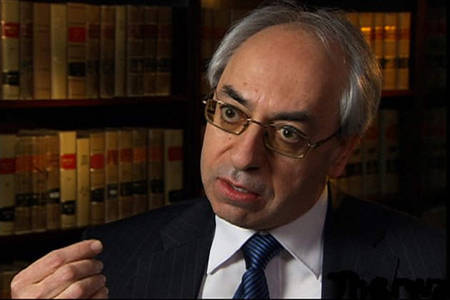الثورة السورية كاشف أخلاقي هَتَكَ سترَ الجميع
عبدالباسط سيدا
تشكّل الثورة السورية تحوّلاً نوعياً نادراً في تاريخ واحدة من أهم مناطق العالم وأكثرها حساسية وتداخلاً، خاصة على صعيد البنية الدينية – المذهبية، هذا ناهيك عن المكانة الجيو – سياسية والاقتصادية. تتأتى الأهمية الاستثنائية للثورة السورية من كونها أحدثت خلخلة كبرى غير مسبوقة في بنية منظومة الاستبداد والفساد، التي تمكّنت على مدى عقود من تسطيح العقول وتسفيه القيم، وتجاوزت كل الحدود المعرقلة لجهود أصحاب تلك المنظومة. ولم تكن الخلخلة تلك غير مؤلمة، بل كانت – وما زالت – قاسية، تسبّبت في خراب منقطع النظير على مستوى الإنسان والحجر، كما تسبّبت في تفتق الطاقات، وتفجير العقد على المستويين الفردي والمجتمعي.
فعلى مستوى الفرد، مكّنت الثورة النخب السورية من مد جسور التواصل والتعارف في ما بينها، والدخول في حوارات معمّقة ساعدت على فهم الهواجس بصورة أفضل، وأبرزت الكثير من القواسم المشتركة التي كانت متباينة غير محددة المعالم في ما مضى. ولكنها في المقابل بينت مدة تحكّم المنظومة المفهومية التي رسخّتها سلطة الاستبداد على مدى عقود في ذهنية بعض النخب، فلم تتمكن من رؤية الوضعية الجديدة بمنظار جديد يكشف النقاب عن موطن الخلل وبواعثه، فظلّت تحلم بالمشاريع القومية والدينية التي ثبت باستمرار بُعدها من الواقع وتناقضها معه. وقد أدى هذا التوجه إلى حالة من الاضطراب العصابي، تجسّدت في مواقف قوموية، مذهبية عصبوية متشددة لدى بعضهم، ونقلات زئبقية من موقف إلى آخر رضوخاً لمستلزمات النزعات الشعبوية لدى بعضهم الآخر.
و لا نبالغ إذا قلنا إن قلة قليلة هي التي حافظت على توازنها، ولم تتأثر بماكينة إعلام النظام وحلفائه، واستطاعت تجاوز الخطاب غير المسؤول الذي اعتمده بعض الأفراد في المعارضة أو من المحسوبين عليها.
وقد ساهمت النزعة «النجومية» على صفحات التواصل الاجتماعي في استفحال حالة انعدام التوازن النفسي، والاستقرار الفكري، لدي العديد من النخب التي كان من المفروض أن تؤدي دوراً أكثر فاعلية على مستوى البحث عن المشتركات، وأقل حدية على مستوى التعامل مع الهيجانات العصبوية والولاءات ما قبل الوطنية.
ما شهدته – وتشهده – سورية منذ أكثر من خمس سنوات من قتل وتدمير وتهجير وتشريد، ومن تدخلات من البلطجيين الإقليميين والمرتزقة المتعددي الجنسيات، هذا إلى جانب التدخلات العسكرية السافرة من جانب إيران وروسيا، كل ذلك يؤكد أن الصراع بين القوى الراغبة في التحكّم بمصير سورية والسوريين، وبين السوريين الراغبين في الانعتاق وتأمين مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة، هو صراع وجودي لا يقبل المساومة أو التوافق على أنصاف الحلول، طالما أن أنصار الوضع القديم المحتضر يصرّون على إخراج الأمور وفق مقاساتهم، وبالتناغم مع مصالحهم. وقد استخدم هؤلاء كل إمكاناتهم المادية في الحاق الأذى بالسوريين قتلاً وتدميراً، كما استخدموا كل أوراقهم وخططهم بقصد إحداث الفتن، وممارسة التضليل والتزييف عبر مفردات باتت من المألوف المقيت.
ولكن في المقابل، هناك من استغل واقع الصراع والفوضى، وغياب الجسم السياسي المتماسك القادر على القيادة والتوجيه، ووضع استراتيجية متكاملة، وتحديد مسارات التكتيك اليومي، فقدّم نفسه بوصفه جزءاً من الثورة وهو على النقيض تماماً مع دوافعها وتوجهاتها وآفاقها. واللافت المؤلم أن قسماً من دعاة التغيير الثوري راهن على هؤلاء، ولا زلنا ندفع ضريبة تلك المراهنات الخاسرة، بل الكارثية.
السوريون بكل مكوّناتهم وتوجهاتهم وجهاتهم من المؤمنين بالعيش المشترك – وهم يمثلون الغالبية الغالبة – بعيداً من التصنيفات المذهبية والمناطقية التي فرضها النظام وأتباعه من جهة، وأمراء الحرب بصرف النظر عن شعاراتهم وادعاءاتهم من جهة أخرى. السوريون المؤمنون بالمشروع الوطني، يريدون جميعاً القطع النهائي مع الواقع الحالي، وتجاوز ثلاثية الشر: الاستبداد والإرهاب والفساد، ويتطلعون نحو إعادة بناء وطنهم ونسيجهم المجتمعي على أسس مدنية ديموقراطية تفصل بين الدين والسياسة، وتضمن التزام سائر الحقوق والخصوصيات على مستوى الأفراد والجماعات. أما على المستوى الإقليمي، فسورية كانت قديماً وما زالت راهناً مقياس توازن المنطقة واضطرابها. وهي قادرة بحكم تركيبتها السكانية وإرثها الحضاري والتوجه الانفتاحي لدى أبنائها، من تأمين التواصل والتحاور بين القوى المتصارعة في يومنا هذا. والتوافق الإقليمي الغائب المطلوب إذا ما تم، فإنه سيضع حداً للعبث الدولي الذي ندفع ثمنه دماً عزيزاً، ونبدد طاقاتنا وثرواتنا، ونقامر بمستقبل أجيالنا.
لن تعود الأمور في سورية إلى ما كانت عليه قبل الثورة مهما ارتكب النظام من جرائم، ومهما أمعن المتحالفون معه في قتل السوريين وتدمير بلدهم. السوريون قد دفعوا ضريبة باهظة تتمرد على الحسابات التقليدية، وتحمّلوا ما لا يتحمله أي مخلوق أو كيان. ولن ينعم الاستبداد بالاستقرار والأمن، سواء في سورية الكبرى التي نريدها أو في سورية «المفيدة» التي يريدونها. كما أن الإرهاب الذي يتبادل الأدوار مع الاستبداد ويستمد نسغه منه ويمدّه بالطاقة، لن يعيش في سورية، فهو مجرد ورم سرطاني، يتقاسم الماهية مع النظام الذي أنتجه، وسيتم استئصاله عاجلاً أم آجلاً.
ما تمر به سورية، والمنطقة بأسرها، يمثل في جانب كبير منه تجليات مخاض عسير، سيدفع بمختلف الأطراف نحو الإقرار بضرورة، بل بحيوية فصل الدين عن الدولة بما يتناسب مع خصوصية المنطقة وإرثها الحضاري وهويتها الثقافية. وهذا معناه أن العلمانية المتوحشة الأشبه ما تكون بعقيدة متكلّسة رافضة للآخر المختلف، لن تجد أرضية خصبة لها في مجتمعاتنا رغم تعلّق سائر المتسلقين بها، هؤلاء الذين يتماهون في نمط التفكير مع كل العقائد المذهبية التي يتستر خلفها أصحاب المشاريع الانتقامية.
لقد باتت الثورة السورية كاشفاً أخلاقياً – على حد تعبير أستاذي الدكتور صادق جلال العظم – أظهر بكل وضوح تهافت المزاعم والادعاءات، وكشف عورات الجميع، فظهرت القباحات على حقيقتها بعد أن تلاشت مفاعيل مساحيق التضليل الرخيصة. وبانت حقيقة الأكاذيب التخديرية الخادعة، وبدا العالم كله مشلولاً في مواجهة نظام أرعن، إن لم نقل متناغماً، أو حتى متحالفاً معه. الشعب السوري يدفع فدية ليس في مقدور أي إنسان تخيل جسامتها ثمناً لحريته، ولكنه في الوقت ذاته يكتب سفراً جديداً يتناول الأزمة القيمية العميقة على المستوى الكوني، وهو سفر سيضاف إلى الأبجدية التي قدمها إلى العالم في سالف الأزمان، تلك الأبجدية التي يبدو أن الكثيرين لم يفقهوا بعد دلالاتها وأبعادها.