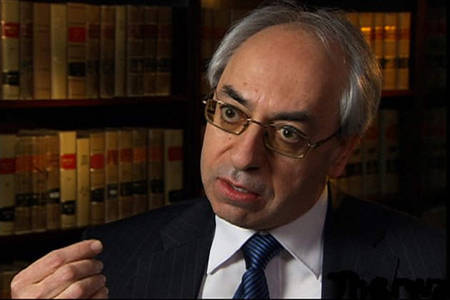منطقتنا في انتظار أقدارها
عبدالباسط سيدا – الحياة
نقرأ يومياً العديد من التحليلات المعنية بالدور الأميركي في المنطقة من جهة الحدود والطبيعة والآفاق، يستند أصحابها إلى المعطيات الواقعية التي تتبلور ملامحها تباعاً. وفي حال عجزِ المعطيات عن تفسير كل تشعبات المشهد وتعقيداته، تأتي التكهنات في محاولة لإعطاء تصور مقنع لمستقبل المنطقة، وطبيعة المعادلات التوازنية الجديدة التي ستتحكّم بأدوار الفاعلين الإقليميين.
ويتمحور معظم التحليلات المعنية حول ما إذا كان قد تم توافق أميركي- روسي، يمكّن الولايات المتحدة الأميركية من تجاوز مصاعب مرحلة القطب الواحد التي شهدها العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ويشار هنا على سبيل الذكر لا الحصر إلى حروب تحرير الكويت، وأفغانستان، والعراق. فقد كان كل ذلك باهظ التكاليف أميركياً في مختلف الميادين. ولم تسفر مآلات الحروب المعنية عن الذي كان يُبشّر به على المستويين الأكاديمي والسياسي الشعبوي. فلم تجد المنطقة استقراراً، ولم تشهد ديموقراطية ولا تنمية. كما لم تتحوّل المنظومة الغربية المفهومية والتطبيقية بنكهتها الأميركية الأنموذج السائد كما توقع فوكوياما في حينه، بل أصبحنا نعيش واقعاً أقرب ما يكون إلى تحليلات وأفكار هانتنغتون حول صراع الحضارات أو تصادمها.
هذا في حين أن تحليلات أخرى تفسّر الواقع الراهن عبر التركيز على الخلل في عملية اتخاذ القرار الأميركي، ولفت الأنظار إلى الترهل الواضح على المستوى الأوروبي، الأمر الذي مكّن الروس والإيرانيين من استغلال الموقف، وملء الفراغ، بغضّ النظر عن أسبابه وأهدافه.
وما لا خلاف حوله، هو أن الروس قد ثبّتوا أقدامهم في المنطقة، سواء أكان ذلك ضمن توافق مفترض بينهم وبين الأميركان، أو نتيجة الارتباك في الموقف الأميركي نتيجة تبدل الاحتمالات والأولويات. ويستدل على ذلك من التقارب الكبير بين الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة وروسيا. وهذا ما يمنح الأخيرة المزيد من الخيارات، وترجمة ذلك المزيد من القوة في منطقة منهكة بالصراعات وانفجار الولاءات ما قبل الوطنية.
فبعد التنسيق العسكري والأمني الروسي والإسرائيلي على أعلى المستويات، جاء التقارب، ومن ثم التفاهم والتوافق الروسي- التركي الذي تجسّد في اجتماعات آستانة، وما تمخض عنها، لا سيما اتفاقيات مناطق «خفض التوتر» التي حددت مناطق النفوذ الخاصة بالقوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري من جهة، وأفرغت بيان جنيف1 من محتواه، بما يعنيه ذلك من تمهيد للطريق أمام إعادة تأهيل نظام بشار من جهة أخرى.
وقد مكنت الاتفاقيات المعنية الروس من التغلغل في ثنايا الوضع الداخلي للفصائل والقوى العسكرية التي كانت تقاتل النظام من أجل إسقاطه، فتحوّلت نتيجة الضغوط المختلفة إلى أدوات ضمن الاستراتيجية الروسية المتمحورة حول هدف الإبقاء على النظام بذريعة محاربة الإرهاب، الذي يتم توسيع نطاق ما صدقه، أو تضييقه، وفق الاحتياجات التكتيكية التي لا بد من مراعاتها من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.
ومن الملاحظ أن الدور الروسي بات هو الانزيم المعتمد لتحقيق صيغة من التكامل بين القوى الإقليمية المتعارضة، لتنصب جهودها في نهاية المطاف في الاتجاه ذاته، بغض النظر عن طبيعة التعارضات أو التناقضات في ما بينها. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى أدوار كل من مصر وإيران وتركيا.
وجاءت الزيارة الأخيرة للعاهل السعودي إلى موسكو لتؤكد وجود نزوع واضح لدى الحلفاء التقليديين لأميركا نحو الانفتاح على روسيا، وبناء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، فضلاً عن طلب المعونة منها في العديد من الملفات الساخنة التي تهم الجانبين، منها الملفان السوري واليمني، والوضع في منطقة الخليج، ومستقبل العلاقة مع إيران.
والأسئلة التي تفرض ذاتها هنا هي: هل ما تشهده منطقتنا من تحرّكات ومتغيرات مستجدّة يدخل ضمن إطار عملية إعادة توازن جدية؟ أم أنها نتيجة خلل استراتيجي نجم عن إحجام الإدارة الأميركية في عهد أوباما عن التعامل من موقع الفاعل مع قضايا المنطقة، واكتفائها بنهج إدارة الأزمات عوضاً عن إيجاد الحلول لها؟
وهل ستتمكن إدارة ترامب من تجاوز تبعات ذاك الخلل، في حال وجوده؟ أم أن التكهن بما ستكون عليه الأمور من أجل استعادة زمام المبادرة مع زال في حكم الغيب الترامبي؟
الصورة ليست واضحة بعد. وما زال الجميع في انتظار تبلور الملامح النهائية لسياسة الرئيس الأميركي حول المنطقة. والكل يعلم أنه من دون حدوث اختراقات واضحة قبل نهاية السنة الأولى من ولايته، فإن سقف التوقعات سيتراجع بحدّة، وستكون مختلف الوعود الأميركية حول مستقبل المنطقة موضع جدل وشك عميقين.
وفي هذه الأجواء، كانت استراتيجية ترامب الخاصة بالتعامل مع الدور الإيراني في المنطقة. التي ركزت على السرد التاريخي لممارسات إيران التخريبية والإرهابية في المنطقة، سواء بصورة مباشرة، أم عبر أذرعها من المنظمات والميليشيات، وفي مقدمها «حزب الله».
والأمر الذي يستوجب التوقف في شأن هذه الاسترتيجية هو النقد الأوروبي العلني لها. وأمر كهذا يجد تفسيره في معطيين. الأول: اهتزاز الثقة بين الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب وحلفائها التقليديين من الأوروبيين.
أما المعطى الثاني، فله علاقة بالمصالح الاقتصادية الأوروبية مع إيران التي استعادت حيويتها بعد حصول الأخيرة على أرصدتها المجمدة، وذلك مكافأة لها مقابل توقيعها على الاتفاقية النووية.
ومن الواضح أن الموقف الأوروبي هذا يتقاطع في جانب كبير منه مع الموقف الروسي، الأمر الذي يحرج الإدارة الأميركية من دون شك، ويحدّ من مساحة خياراتها.
لقد حوّل ترامب ملف الاتفاقية النووية الإيرانية إلى الكونغرس، كما فعل سلفه أوباما في حينه مع الملف الكيماوي السوري. ومن المتوقع أن تكون النتيجة هي ذاتها، الأمر الذي سيفتح الباب أمام جهود توفيقية لن تساهم في عملية القطع مع النهج الأميركي المُعتَمد حتى الآن للتعامل مع قضايا المنطقة، وهذا مؤداه بقاء أزماتها مفتوحة إلى إشعار آخر، وذلك بفعل غياب الدور الأميركي الفاعل، وعدم قدرة الروس على حسم المسائل بمفردهم. بينما أوروبا حائرة مشغولة بقضاياها الداخلية. تعمل من أجل الحفاظ على التوزان في علاقاتها مع حليف أميركي تاريخي أصابها بالإحباط، وخصم تاريخي يسعى لاسترجاع موقعه، خصم لم يتمكن بعد من إقناعها بإمكان بناء صيغة جديدة من العلاقات الودية المستقرة.
أما القوى الإقليمية، فهي تحاول أن تضع قدماً هنا وقدماً هناك، في محاولة منها لتجاوز آثار بركان الصراعات على المنطقة وفيها بأقل الخسائر الممكنة. وبأدوات لم تعد صالحة لهذا العصر وتحدياته.