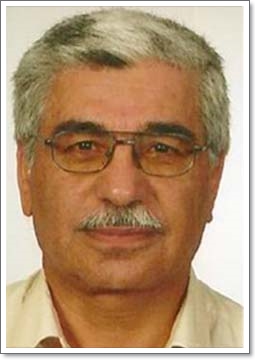الدور التاريخي للبارزاني في الحركة التحررية الكوردية
بعضهم يقول صادقاً: “هذا الشبل من ذاك الأسد” ويعني الكورد بالأسد: القائد الخالد مصطفى البارزاني الذي لعب دوراً تاريخياً فذاً في قيادة الحركة التحررية لعقودٍ طويلةٍ من الزمن، مقاتلاً صنديداً يحسب الأعداء لقواته المتواضعة “البيش مرﮔه” أو “الذين يجابهون الموت، ألف حساب، على الرغم من ضعف الإمكانات المادية وقلة السلاح الذي كان في أيدي محاربيه الشجعان.
لقد كان الإطار الظرفي الذي عاش وكافح فيه الأب البارزاني، الذي يعتبر من أهم قادة الكورد وأجدرهم في التاريخ منذ صلاح الدين الأيوبي، غير الإطار الظرفي الذي يقود فيه الأخ المناضل مسعود البارزاني شعبنا، دولياً واقليمياّ وكوردستانياً، حيث أدار العالم الاشتراكي بأسره ظهره للحركة التحررية الكوردية في زمن الحرب الباردة، على الرغم من أن قائدها البارزاني مصطفى التجأ على أثر قضاء الشاه الإيراني على جمهورية كوردستان (عاصمتها مهاباد) في عام 1947 إلى الاتحاد السوفييتي وليس الغرب الرأسمالي، وظل هناك لمدة 12 عاماً، لم يقم فيها بأي نشاطٍ معادٍ للسوفييت والشيوعية، وحرص على إقامة علاقاتٍ متوازنة مع الحزب الشيوعي السوفييتي من دون أن يتخلى عن دوره الهام في قيادة حركة شعبه الكوردي، في حين اعتبر العالم الرأسمالي (أوروبا والولايات المتحدة خاصةً) حركة هذا الشعب، الوطنية الديموقراطية، ذات الأهداف المشروعة والعادلة، على أساس حق تقرير المصير للشعوب، مضرّة بمصالحه وعلاقاته في منطقة الشرق الأوسط، وقائدها ليس إلاّ (ملا أحمر) أي “شيخاً شيوعياً”، وكانت الأحزاب الشيوعية في المنطقة تعادي البارزاني مصطفى وحزبه الديموقراطي الكوردستاني حسب الظروف والأجواء المتغيرة، وعلى الضد من مستوى علاقاتها بالنظم الحاكمة في البلدان التي تقتسم أرض ووطن الكورد “كوردستان”، وعلى الأغلب كانت معادية للبارزاني الخالد والحركة الثورية التي يقودها.
وعندما انهارت الثورة الكوردية (1961-1975) التي خاضها ضد الحكومة المركزية في بغداد، بسبب الدعم التام والكبير سياسياً وعسكرياً لنظام صدام حسين الدموي من قبل المعسكر الاشتراكي، مقابلة خيانة العالم الغربي للثورة الكوردية آنذاك وبسبب عدم وفاء وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر آنذاك لوعوده بتقديم الدعم ومساندة الكورد لردع النظام المركزي، واستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم ومساندة الشاه الإيراني الذي بدأت نيران المعارضة تغلي تحت عرشه، وقف البارزاني مصطفى الحكيم ليقول لشعبه في محنته الكبرى بشجاعة المحارب المنهزم: “إن دوري في قيادة الشعب الكوردي قد انتهى، والشعب الكوردي سينتج من بين صفوفه قيادةً جديرة له.” وقال أيضاً في تلك الأيام العصيبة: “إن أكبر خطأٍ في حياتي هو وضعي ثقتي في دولةٍ كبيرة.” وبذلك بدأت مرحلةٌ جديدة من مراحل الكفاح التحرري الكوردي، الذي لعب فيه إقليم جنوب كوردستان ولا يزال يلعب دوراً هاماً وطليعياً لكفاح شعبنا من أجل الحرية والحياة.
لا يمكن هنا تجاهل دور البيشمركة الكبير الأخ المناضل إدريس البارزاني الذي وجد أمامه شعباً مشرداً وقواتٍ مبعثرة بدون إمكانات وأصدقاء، في حين ارتفع عدد الجحوش والعملاء ومرتزقة النظام الصدامي، حيث عمل صدام حسين في تلك الظروف السيئة للكورد استغلال الهزيمة الساحقة التي ألحقها بهم، بدعم سوفييتي شامل وفي ظل صمتٍ عربي وإسلامي ودولي تام، فقام بتهجيرٍ جماعي للعشائر الكوردية الوطنية الاتجاه وتخريبٍ وهدمٍ للبنى التحتية في كوردستان ولآلاف القرى، إضافةً إلى مناطق معزولة من السكان، وتلغيم مساحاتٍ شاسعة حول المدن والمناطق التي قد يتسلل منها البيشمركه من خارج الحدود، وإقامة كيانٍ مشّوه وعميل من إدارةٍ محلية للمرتزقة الكورد سماها ب”الحكم الذاتي”، بهدف تضليل الرأي العام العالمي وتدجين الكورد وترحيلهم وتعريبهم…
في تلك المرحلة التي كان يصعب لأي قائدٍ سياسي وعسكري الصمود، وقف القائد المحارب إدريس البارزاني وإلى جانبه مسعود البارزاني البيشمركة الشاب والسياسي الذي تربّى مع أخيه على أيادي القائد الأب، وكان وقوفاً شامخاً وعظيماً، ولولا تلك المواقف الشجاعة لانهارت قوات البيشمركة وتلاشت الجهود القومية لعقودٍ من الزمن، إذ مرّت الحركة القومية لشعبنا آنذاك في أحلك الظروف الوطنية والإقليمية والدولية. ولله في خلقه شؤون، فقد التحق القائد إدريس بأبيه الراحل في وقتٍ عسيرٍ للغاية، لتقع مسؤولية هذا الشعب بالدرجة الأولى على عاتق القائد الجديد مسعود البارزاني، حيث تبعثر الرجال الذين كان الحزب والبيشمركه يعتمدان عليهم، فرادى وبالجملة.
وبدأت ملامح الأوضاع الإقليمية تتغير، لصالح شعوب المنطقة ومن بينها الشعب الكوردي، فقد اندلعت ثورة شعبية عارمة في إيران، وتم انهاء وإلغاء حكم الشاه الذي لم يجد في العالم دولةً تستقبله كلاجىء سياسي. وفرح الكورد لذلك كثيراً لأن الشاه كان شريك صدام حسين في إلحاق الهزيمة بقائدهم البارزاني وثورتهم المجيدة، وبعد فترةٍ قصيرة تصادم النظامان العراقي والإيراني اللذين استولى كل منهما على جزءٍ من أجزاء كوردستان الأربعة، بعد أن مزّق صدام حسين ما توصل إليه من اتفاق يصدد كوردستان والحدود مع الشاه الإيراني وأعلن إلغاءه رسمياً، مما أضعفت الحرب التي دامت أكثر من ثماني سنوات قوى الدولتين، الحربية والبشرية والمالية، كما تعاظمت الحركة القومية الكوردية في كل أنحاء كوردستان، واتخذ الكورد في شتى أنحاء العالم موقفاً داعماً للثورة التي بدأت تعزز من مواقعها من جديد في جبال كوردستان المروية بالدماء، على الرغم من سياسة التهجير والتقتيل والتعريب والإرهاب الشاملة، وازداد القائد مسعود البارزاني إصراراً على أن لا مجال للتراجع عما بدأ به جده وأباه وأخاه، من قبل، وهكذا انفتحت نوافذ إقليمية وأبواب ضيقة أمام حركة التحرر الكوردية، ولكن الدول المعادية للكورد وكوردستان كانت له بالمرصاد، فجاءت كارثة حلبجة الكبرى في عام 1988، التي راح ضحية القصف الكيميائي على تلك المدينة الكوردية أكثر من 5000 إنسان من المدنيين العزل، وتوسعت الإجراءات الإجرامية لصدام حسين بإعلانه حرب “الأنفال” على الشعب الكوردي، إلاّ أنه لم يكن يدري مدى خطورة استخدامه السلاح الكيميائي دولياً، وما تفعله هكذا جريمة في وعي الشعوب والأمم المتقدمة في مجال حقوق الإنسان… ثم وقع الذئب الشرس في إحدى أكبر أخطائه الاستراتيجية باحتلاله الكويت في عام 1990، حيث بدأ الإطار الظرفي للعبة الموت والحياة في كوردستان التي لاتزال جزءاً من العراق بالتغير، حيث العراق هي الدولة التي بدأت بالغزو في بلدٍ منتجٍ للبترول وله أهمية قصوى لموقعه على الخليج في مقربةٍ من إيران التي تريد أن تصدّر “الثورة الإسلامية” إلى كافة الأنحاء، فكانت تلك المغامرة التي فتحت على صدام العرب “حامي البوابة الشرقية!!!” أبواب الجحيم..
جان كرد